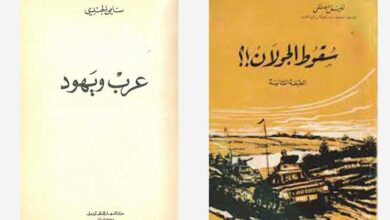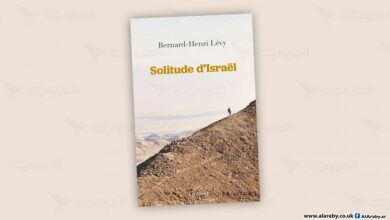سؤال ساخر في وجه خراب الذاكرة/ عمار المأمون

لا نعرف من ألّف كتاب الخطابة لهرنانوس (Rhetorica ad Herennium) الذي يعود تاريخه إلى عام 80 قبل الميلاد. كان الكتاب يُعزى لشيشرون، وتبين لاحقاً خلاف ذلك. في هذا الكتاب التعليمي عن أصول البلاغة وإبراز الحجة لإنتاج «الحقيقة» أمام جمع من الناس، نقرأ عن «فن الذاكرة»؛ تلك القدرة على استعادة ما مضى وجعله حاضراً في لحظة القول أو المواجهة، فالذاكرة هي «صندوق الكنز» الذي يخفي كل تقنيات البلاغة.
سمّى المؤلف المجهول الذاكرة فنّاً بسبب وجود تكتيكات عقلية لاستحضار الماضي أو الحفاظ عليه، أساسها ترتيب عناصر العالم وما فيه داخل العقل/ المخيلة. لا نتحدث هنا عن الذاكرة الطبيعيّة، بل تلك الاصطناعيّة التي تتكون من «صور» و«خلفيات» تُحفظ داخل العمران المتخيّل للذاكرة.
الخلفيات هي الأماكن الصغيرة المكتملة في العقل، والتي يمكن العودة إليها دائماً: كالمنزل، أو المساحة بين عمودين. أما الصور فهي علامات مميزة: كشخص، أو صورة. ولكي نتذكر، علينا وضع كل صورة في خلفية، لأن الخلفية أشبه بـ«لوح شمعي» أو «ورق بردي». أما الصور فهي كالأحرف، وترتيب الصور على الخلفيّة يُفعّل الذاكرة ويحفظها.
يستطرد المؤلف لاحقاً ليخبرنا أن الصور والخلفيات التي يتم ترتيبها في عمران الذاكرة تشبه البناء أو المدينة، يمكن للفرد أن يتنقل بينها ليستذكر ويستعيد ما حفظه: بيوت ثم غرف ثم نوافذ يمكن التنقل ضمنها والاطلاع على ما فيها. والأهم هو التمرين للحفاظ على ترتيبها كي لا تنهار «الذاكرة»، أو بكلمات أخرى: كي لا ينسى الفرد ما يريد أن يحافظ عليه.
«أتذكر كي لا ننسى»
«أتذكر» هي الكلمة السحريّة التي تتكرر في كتاب فنانون سوريون في المنفى – أعمال فنية وحكايات الذي أعدّه كل من دنيا الدهان وكورين روندو. كلمة «أتذكر» تكتسب في الكتاب قدرة تأويلية، كونها فاتحة لنصوص على لسان فنانين سوريين في المنفى تعرفنا على أعمالهم الفنية في الكتاب وفي صالة مالكاوف للفن في باريس ضمن معرض أُقيم العام الماضي بعنوان أين منزل صديقي؟
تُحيلنا كلمة «أتذكر» إلى الافتتاحيات الشهيرة مثل «كان يا مكان في قديم الزمان»، أو «أبرا كدابرا»، التي يقال إن أصلها آرامي، وتعني «أخلق بينما أتحدث». لكن في كلمة «أتذكّر» والخصوصيّة السوريّة للمعرض والكتاب، يمكن تفسير الكلمة بـ«أتذكر وأخلق، كي لا ننسى ما حصل في قديم الزمان». هناك مسؤولية جماعية من نوع ما نقرؤها في شهادات الفنانين الأربعة والعشرين الحاضرين في الكتاب، كون أعمالهم تخاطب أحداثاً وذاكرة يحاول النظام السوري طمسها.
تشير الدهان إلى العلاقة مع الذاكرة في النص الذي كتبته بعنوان العبور عبر المرآة (la traversée du miroir)، إذ تُحدثنا عن المرات العديدة التي استعادت فيها حكاياتها وحكاية سوريا ضمن سياقات مختلفة، جدّية وغير جدّية؛ حكايات ما زالت تتكرر ضمن السنوات «الضائعة»، حسب تعبيرها، ويعيشها من تركوا سوريا محدقين في ذاكرتهم وفي الشاشات لمعرفة ما يحصل في «الداخل».
تُخبرنا الدهان عن معرض «أين منزل صديقي؟»، الذي اقُتبس اسمه عن فيلم لعباس كيروستامي. ونقرأ عن مراحل تنظيمه وكيفية اختيار الأعمال ضمنه، والتي كان معيار عرضها النوعية والجودة لا الحكاية الشخصيّة أو «وضعية الضحيّة» أو «اللاجئ» أو أي من الصفات التي تُلصق بأي سوريّ. وتنتقل الدهان إلى حكاية الكتاب، أو إلى الذاكرة السورية من وجهة نظر فنيّة، مشيرة إلى التعامل مع الفنانين لم يتم بوصفهم «لاجئين، أو ناجين أو معذبين»، بل كأصحاب تساؤلات فنيّة لا تصبغها السياسة بشكل كليّ، وإنما أثرت عليها الأحداث بشكل استثنائيّ هدد ذاكرة الفنانين وما يعرفونه عن «الماضي» جمالياً أو سياسياً. وهنا تظهر الأسئلة الأربعة التي طرحتها الدهان على كل واحد من الفنانين:
1-ما هي الأحداث العامة خلال السنوات العشر الماضيّة التي أثرت بك بشدة؟
2- ما هي الأحداث الشخصية خلال السنوات العشر الماضية التي لمستك بشدة؟
3- من أنت اليوم؟
4- من ستكون بعد عشرة أعوام؟
هذه الأسئلة لا ترتبط بمضمون اللوحات المعروضة، بل تقدم نصاً تعريفياً عن كل فنان يختلف عما نقرؤه عادةً، لنرى أنفسنا أمام ما يشابه الشهادات التي تبدأ بالافتتاحيات التاليّة: «أتذكر»، «ما مسّني»، «اليوم»، «بعد عشر سنوات». نعود هنا إلى تمارين الذاكرة السابقة، فـ«الخلفيّة» المشتركة بين الفنانين هي سوريا، أو بصورة أدق لحظة من الثورة السوريّة: منزل، ساحة، مظاهرة. وهي خلفية تشكّل الذاكرة الجمعيّة لكل من تتحدث معهم الدهان. ثم تأتي «الصورة»، أي الحدث أو التفصيل الذي لا يمكن نسيانه. لكن بعكس التمرين السابق، تعدّ هذه الصورة عنيفة، وتهدد عمران الذاكرة نفسه، وأحياناً لم يختر الفنان أن يضعها في ذاكرته. فبيسان الشريف، الفنانة الفلسطينية السوريّة، تتذكر دفتراً في مشفى عليه أسماء موتى رحلوا «لأسباب غير معروفة»، وهي صورة لم تفارقها حسب تعبيرها. أما عزة أبو ربيعة فتتذكر حلماً جماعياً راودها هي والسجينات في الزنزانة عن حوت حملها ومن معها إلى الخارج.
عمران الذاكرة، ولو بالمعنى الحرفيّ، هو صورة ما قبل الحطام. لكن بعد 2011، نكتشف أثر العنف على هذه الذاكرة ضمن الأعمال الفنيّة: غُرف مدمرة، وشوارع مليئة بالجثث، ورأس السلطة القبيح الذي لا يتزحزح. العنف الشديد الذي شهدته سوريا نسف «الصور» و«الخلفيات» التي تشكل ذاكرة الفنانين المُنتمين إلى «الآن» و«هناك»، لتبدو أعمالهم محاولات للترميم والتقاط ما تبقى، خصوصاً أن هناك جهداً مضاداً لتنظيف وتبيض ما حصل.
تُحدثنا الدهان عن نتائج بحثها عن الفن السوري المعاصر على غوغل. وتخبرنا أن أول ما ظهر أمامها هو فيديو طويل لتكريم للفنانين في دار الأوبرا (دار الأسد في دمشق)، وكأننا أمام صور وحكايات رسميّة مرحة تبيّض وجه النظام. ترى الدهان أن سياسة التبييض هذه تجلّت بأوجها ضمن احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربيّة عام 2008. هذا الحدث الثقافي فتح سوريا وفنانيها على تجارب جديدة وأشكال تعبير مختلفة، لكن الأمر لم يتغير حتى الآن، كأن شيئاً لم يحصل منذ عام 2011، لا فقط على صعيد الرقابة، بل أيضاً على صعيد الموضوعات. ما حصل في الثورة كان مصدراً للإلهام لبعض الفنانين، والنساء اللواتي خطن الأعلام ورسمن في السجون ورفعن اللافتات كن السبّاقات في ممارساتهن الفنيّة الحيويّة المرتبطة باللحظة. هذه الممارسات لم تظهر جمالياً في الأعمال الرسمية في سوريا، بل اتضحت في الجانب الآخر، الرافض للرقابة، الذي وجد في هذه الممارسات موضوعات فنيّة صالحة للمسائلة والمحاورة.
قراءة مع سوء نيّة
هشاشة الذاكرة السوريّة في المنفى لا ترتبط فقط بالعنف الذي شهده وتعرض له الفنانون أو الفاعلون في الفضاء الثقافي، بل تمتد نحو إشكاليات الإنتاج وسوق العرض الذي يحكم الفنانين السوريين في أوروبا، والذي قد يؤثر على مضمون الحكايات التي يريدون تقديمها. هذه العوائق والإشكاليات يعيها القائمون على المعرض والكتاب، فهناك سعي لتجاوز الحدود الجمالية والسياسيّة التي توضع حول «السوري» لضبطه في خانة محددة. هذه الخانة أو «مساحة اللعب»، لا تتيح له الاختلاف عن مواطني البلد المضيف إلا لكونه سوريّاً، لا لكونه فناناً ذا موقف جمالي من العالم.
مع ذلك، فهناك وصاية من نوع ما، أو قد لا يكون ممكناً دخول «سوق الفنّ» أو «عالم الفنّ» في فرنسا وأوروبا دون «آخر» يلعب دور الوسيط القادر على تقديم هذا الفن للعلن، وأحياناً «ضبط» صوت الفنان. لا نحاول هنا أن ننفي أهميّة هذا الوسيط، وإنما نشير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه في صياغة «الحكاية السوريّة» و«صوت الفنان».
هذا الحديث عن «الآخر الوسيط» تلمّستُه شخصياً حين قرأتُ، بسوء نيّة مُتعمّد، وصف الدهان لأسلوب إجرائها المقابلات مع الفنانين، إذ تقول أن الإجابات التي نقرؤها مرّت بعدة مراحل: مقابلات شفويّة عبر سكايب، ثم ملاحظات للدهان بالعربية السوريّة (تفريغ المقابلات)، ثم الترجمة الشفويّة إلى الفرنسيّة التي قامت بها الدهان عبر بولين دو لا بوالاي، التي نقلت الإجابات إلى الفرنسية باحثةً عن الكلمات الدقيقة للتعبير عما قاله الفنانون حرصاً على الأمانة. وتشير الدهان إلى أن هذه النصوص «ليست بيانات ولا حكايات وتحافظ على شفهيتها، وهي ذكريات ومشاعر وانطباعات وأحلام مقتطعة من الحوارات».
عملية الترجمة السابقة لا علاقة لها بالعمل الفنيّ أو الحكم عليه لدى تلقيه، بل بأسلوب صياغة «حياة الفنان» وتقديم صوته للآخر ضمن الفضاء الفني. نكرر هنا مرة أخرى، بسوء نيّة متعمد، أن الإشكاليّة تكمُن في غياب التطابق بين ما نطقه الفنان وما نقرأ، خصوصاً أن الإجابات تبدأ بضمير الـ«أنا» في حديث عن ذكريات وانطباعات وأحكام تختلف من فنان إلى آخر. لا نقصد هنا التشكيك بالمكتوب، بل مساءلة المؤسسة الفنية الغربيّة نفسها، وقواعدها وموقفها الجمالي والخطابي من هذا «الفن السوريّ» الذي يظهر عبر التعاون بين محترفين سوريين وآخرين فرنسيين وأوروبيين.
إشارة الدهان إلى هذه العمليّة هي دلالة، وإن كانت بسيطة، إلى المراحل التي يتم عبرها نيل الاعتراف بالمنتج السوريّ في المنفى. هناك وسطاء مختلفون يمهدون الطريق للعمل الفنّي ويساهمون بصناعة سرديّة الفنان الخاصة، أي حكايته التي تظهر خارج إطار العمل الفني، والمرتبطة به كشخص وفرد في المجتمع يحاول دخول السوق الأوربيّة والمحافظة على صوته المتفرّد.
نعود هنا إلى الـ«أنا» التي تهيمن على شهادات الفنانين. فصوت هذه «الأنا» قبل قراءته على الورق، مر بعدة مراحل لغوية، وجرت عليه تعديلات طفيفة في الترجمة والتنسيق كي ينتقل من العربية المحكية باللهجة السورية إلى الفرنسية المكتوبة الجاهزة للنشر. صحيح أن هذه العملية تراعي حساسيّة كل فنان وكلماته، لكننا في الحقيقة نقرأ «أصواتاً» مُعدّلة، تمرّ جملها و مجازاتها وهنّاتها وسكتاتها عبر شخص المترجم، الذي لا نشكك بمصداقيته أو أهوائه، وإنما نشير إلى طبيعة وجوده كوسيط «يُسهم في اختراع حياة الفنان»، حسب تعبير بيير بورديو، وتشكيلها ضمن الحدود الثقافيّة والفنيّة.
موقع الجمهورية